كيف نغسل أيدينا من الدماء؟
يستحيل على أي شخص كان ألا يكون مؤججا بالمشاعر
الضارية من أول الحزن واليأس إلى الغضب والثورة إزاء ما يحدث في فلسطين والساحة
الدولية في الفترة الحالية، وأعتقد أن هناك سببا غير مرئي لتلك الثورة المضطرمة
وهو شعور بالاصطدام بواقع لا مفر منه؛ أي أننا بشكل ما اشتبكنا أخيرا مع واقع طال
تجاهله حتى صارت مواجهته شديدة القسوة، وما أقصده هنا ليس أن ما يحدث حاليا ليس
ظلما بينا يستحق الألم الذي نشعر به، لكنني فقط أرى أن الأمر كمريض ترك إصبع قدمه
الصغير مجروحا بشكل بسيط حتى ما استحال الموضوع لعدوى أصابت رجله كلها يصعب عليه التعايش معها وعلاجها مؤلم لكنه ضروري، وكذلك هو الحال مع المجتمع الدولي والشعوب المجاورة لفلسطين التي تبكي عند
كل حادثة ثم تمر مرور الكرام، وأعتقد أن تلك الصدمة بانعدام امكانية استمرار الوضع
إنما هي طلق لولادة عالم جديد حتى وإن لم تتحرر فلسطين بشكل كامل في المستقبل
القريب.
إن ما يحدث الآن هو شوكة في تنغز في ضمائرنا كي
تحييها، ليس فقط اتجاه فلسطين وإنما المعذبين في الأرض كلها، ولكن على الرغم من
ذلك فإن مواجهة الأزمات الصراعات تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة ويستحيل معها أن
يكون هناك "سلاما نفسيا"، ونحن كبشر نميل في بعض الأحيان لتبرير بعض أوضاعنا
الشخصية القائمة بشكل أجوف مغلف بالمنطق حتى نظل على الشط، حتى لا ننزل إلى المحيط
الذي نجهل ما يخبئه لنا.. وعليه فإنني؛ حيث إنني أقل من أن أضيف قولا واحدا على ما
قيل في حق القضية، سأحاول فقط بيان بعض الحجج التي يستخدمها أشباه المثقفين حتى
يتحاشوا مواجهة العالم والوقوف في وجهه.
لندن حماس كلنا!
يستخدم الإعلام الغربي حيلة شديدة الذكاء في
طرح القضية الفلسطينية ينتزع منها بعدها التاريخي، فكأنما يأتي بعدسة مكبرة
للتركيز على جزء من الصورة ويعزل بقيتها بشكل غير مباشر، والمفاجئ أن أغلب
المتعاطين مع القضية يقعون في هذا الفخ فإما يدعمونها فيوصفون بدعم الإرهاب أو يهاجمونها
فيتركوا ثغرة تُبَرَرُ بها العمليات الصهيونية، والمشكلة الأخرى في ذلك السؤال هو
أنه يختزل المقاومة، بل والشعب الفلسطيني كله، في حماس.
وبناءا على اعتبار حماس جماعة إرهابية، فإن
أشباه المثقفين في الوطن العربي ومصر يستخدمون مساوئها في تبرير موقفهم الفاتر غير
المقبول مما يجري، فأنا وأنت لن ندعم بالطبع جماعة إرهابية أليس كذلك؟ ولكن حماس
أُسست عام 1987م، والعدوان الإسرائيلي بدأ عام 1948م، فإن أردنا عرض بعض الأحداث
الإرهابية التي قام بها المحتل فإننا سنجد مثلا مذبحة دير ياسين الواقعة في 9
إبريل 1948م، وحادثة فندق سميراميس في نفس العام، والطنطورة وحيفا، وتطول قائمة
المجازر المقامة بحق الفلسطنين، وبالتالي فإن الحجة القائلة بأن إسرائيل تدافع عن
نفسها ضد حركة إرهابية قذرة، أو التي تدين حماس المعلنة أنها السبب في كل ما يحدث،
لا يليق بها إلا أن نكتبها على منديل نمسح به مؤخراتنا بعد التغوط حقيقةً.
ويقول أحدهم إن
حماس هي صنيعة إسرائيلية غربية وكل ذلك مخطط يستغلونها فيه حتى يتوسعوا ويفعلوا ما
يحلوا لهم، لهو قول يدين إسرائيل أكثر من حماس في الواقع، والمشكلة الأكبر التي
يقع فيها جزء كبير من أشباه المثقفين، الذين تربوا منذ نعومة أظافرهم بالطبع على
المبادئ الليبرالية والديمقراطية الاشمئزاز الرهيب من كل ما هو عربي، هي أنهم
يمسكوا بنفس العدسة التي يمسك بها الإعلام الغربي ظانين أنهم بذلك قد كشفوا
الحقيقة، والغرور الكامن فيهم يشتهي فكرة المخالفة، فالموضوع ليس فقط "خالف
تعرف"، بل كلما خالفت كلما زادت قيمتك، والحقيقة أن المخالفة الحقة هي تلك
التي يقوم بها الشباب اليوم الذين يرون العالم بشكل مغاير عما صُدِّر لهم منذ
نشأتهم.
عواد باع أرضه
يغرد البعض بأن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم
لليهود الذين أنشأوا إسرائيل، والحقيقة أن تلك الحجة هي المفضلة لدي، لأنها مضحكة
إلى حد التقيؤ، فإنني مثلا لن أستعرض نسب الأراضي المبيعة لليهود من قِبَل السكان
الأصليين ثم أقارنها بالمساحة المستولى عليها، لا لا إطلاقا، ولكن السؤال السهل
الذي يمكن طرحه هنا هو: هل يحق لأي أجنبي اشترى أرضا في دولة ما أن يعلنها دولة؟
أي طالب للعلوم السياسية سيجد هذا السؤال محرجا، وعلى الرغم من ذلك أرى أناسا،
أشباه مثقفين، يرددون تلك الجملة مرارا وتكرارا، والفكرة اللطيفة في ذلك السؤال هي
أن الرد عليه لا يدين إسرائيل فقط، بل يعطي الشرعية لأي عمل تقوم به فلسطين إزاء
الكيان المحتل، فأي دولة في العالم أول أولوية لها هي حفظ السيادة، لأنها لو فقدت
سيادتها فإنها لن تعتبر دولة، وبالتالي فإن الدول قد تدخل في صراعات مسلحة مع
فصائل انفصالية، ما بالك بأجانب جاؤوا واشتروا أراضٍ؟ تلك واحدة من أغبى الحجج
التي يتم طرحها في ذلك النقاش، لا يطلقها إلا شخص يخاف أن يشعر عجزه الفائق أمام
فداحة الواقع فيقوم بإلقاء اللوم على شخص مضى على عقد بيع وشراء عادي.
العودة لأرض المعاد
سيحاول البعض إسكاتك بالضربة القاضية، وما هي
إلا غباء بيّن، باستخدام الخدعة الشهيرة المغلفة بالغلاف الديني التنبؤي، فيذكر
شخص ما أن ذلك الله قد وعد بني إسرائيل بأرض الميعاد، وها هم يا ظلمة يريدون أن
يتمموا ما أراده لهم الخالق!
لو أنني جئت بطفل مزعج جاحد متزمر وأخبرته بأنه
لو ظل صامتا سأعطيه كعكةً أضعها أمامه على الطاولة، ثم يوافق ولكنه لا يستطيع أن
يمنع نفسه للأسف من التزمر وإحداث الضجة، فهل يصبح من حقه الكعكة؟ وفي الحقيقة فإن
هنري لورانس، فرنسي الجنسية، في كتابه المهم "الإمبراطورية وأعداؤها" قد
أشار لتلك الفكرة:
"والمشروع الإسرائيلي –حتى المشروع الأكثر
علمانية- لا يمكنه، بحكم طبيعته، إلا أن يتأسس على مرجعية توراتية. ولابد من أن
نضيف إلى هذا التوقير القدسيّ الجديد لذكرى المحرقة. وهذا البُعد الديني، الذي تحس
به البروتستانتية الأمريكية إحساسا خاصا، سوف يؤدي أيضا إلى احتداد مرجعية الجانب
الآخر الدينية. وبشكل تدريجي، فأن ما كان مطروحا من زاوية المعارضة القومية إنما
يتحول إلى نزاع حضارات، وهذا الأخير مصطلح مهذب لتفادي الحديث بشكل أبسط عن حرب
ديانات. وهكذا يجري اختراع أصل <<يهودي – مسيحي>> للحضارة الحديثة،
وهو شيء كان ليثير استغراب الأوروبيين بالفعل قبل 1945."
وقد اصطبغ الصراع بصبغة دينية بحتة، كما ذكر
هنري لورانس، وهذا يشكل مشكلة أخرى من وجهة نظري؛ فالموضوع له بالفعل أبعاد دينية،
لكن حصره فيها يضيق المنبر الذي نخطب من خلاله، بمعنى أبسط، ذكر نجيب محفوظ مثلا
أن الأوروبيين لديهم القدرة على تلوين مشاكلهم بلون عالمي، بالتالي يتأثر بها بقية
العالم، وأرى أن هذا ما نحتاج إليه، فبجانب التناول الديني يجب أن نقدم للعالم
الأزمة على أنها عالمية إنسانية، حتى يستطيع الكل الشعور بأنه محتوى داخلها،
فكثيرا ما نجد مسيحيين عرب لا يشعرون بالانتماء للقضية، ليس لأنهم خونة، وإنما
بسبب تهميشهم المعتاد في الخطابات السياسية، وبالتالي فإنه لو تم تضمينهم في تلك
القضية وتضمنين الكل لأصبح الأمر أفضل كثيرا، وذلك في حقيقة الأمر أصبح يحدث
بالفعل في الفترة الأخيرة إلا أن آثاره لم تثمر بعد عما يجب أن تثمر به، فلا يزال
الكثيرون حول العالم يرون أنها مشكلة المسلمين ضد اليهود فلا دخل لهم بها.
لنلمع أظافرنا
واحدة من أكبر مشاكل أشباه المثقفين هي النزعة
الإنسانية مزدوجة المعايير، وحتى نستطيع شرح المشكلة بشكل كافٍ فإننا يجب أن نصف
شبه المثقف ذلك، علماني في الدرجة الأولى، ليبرالي كما ذكرت سابقا، ويقوم بمقارنة
الدول العربية بإسرائيل دائما، ويرجح كفة إسرائيل بالطبع، ذاكرا بالتأكيد الحياة
الرغدة والتقدم العلمي لإسرائيل مقابل قلة حيلة شعوبنا، وفي تلك الأوقات يعلي كفة
الإنسانية فوق كل شيء ويتحجج مرة أخرى بكون حماس قد هاجمت إسرائيل، مما يدفعني صدقا
للتساؤل كيف يمكن المقاومة؟ النبرة المتعالية التي يستخدمها أولئك تذكرني بشدة
بمهاجمي جمال عبد الناصر- لستُ ناصريا- في كونه السبب في العدوان الثلاثي والنكسة
وكل سيء في مصر، في الحقيقة كان لجمال عبد الناصر كثير من الأخطاء، ولكن كيف كانوا
يريدون التعامل مع الاحتلال مثلا؟ ثم يقولون إنه لو انتظر عشرة سنوات إضافية
لانتهى امتياز قناة السويس! الاحتلال وضع ظالم والتخلص منه أمر عاجل، ما المنطق في
التعامل بإنسانية مع المحتل؟
ولا تغيب عن ذهني مثلا صورة إدوارد سعيد، فهو
أبرز المثقفين عالميا مثلا، وهو مسيحي الديانة، وعاش في الغرب وقتا طويلا ومع ذلك
صورته وهو يقذف الحجارة في اتجاه رمزي للاحتلال واحدة من أفضل ما يعبر عن المثقف،
فهل إدوارد سعيد ناقص الثقافة مثلا؟ أم أنه إرهابي إسلامي متشدد؟ أولئك الذين
يريدون الكفاح دونما تتطلخ أيديهم بالوحل يبدون تماما كمن يريد أن يحصلوا على طفل
من صلبهم دون ممارسة الجنس!
المثقف الذي نستحق قطعا أفضل منه
يحترم جدا العالم الذي نعيش فيه الرجل الذي
يبدو وكأنه يعلم ما يقول وما يفعل جيدا، بل والذي يملك من العقل ما يبهر ومن الحجج
ما يقنع، الرجل الذي يبدو واثقا وقويا
دائما، الظاهر دائما في الصورة الأب الحكيم، وذلك يذكرني بإحدى المقاطع التحفيزية
التي قيل فيها "كم هو سهل أن تصبح عظيما الآن! فالكل ضعفاء.."، وذلك
ينطبق على المثقف الرهيب الذي نتحدث عنه وهو جوردن بيترسون، الطبيب النفسي والمفكر
– تقريبا- الذائع الصيت، والمحبوب جدا في بلداننا العربية من قبل الشباب على مواقع
التواصل.
ولمن لا يعلم لماذا أذكر بيترسون؛ فإنه دعم
إسرائيل بتغريدة عبر تويتر أو إكس موجها إياها إلى نتنياهو قائلا " أعطهم
جحيما! كفى يعني كفى!"، والحقيقة أنني مشخصن للعداوة معه بشكل كبير على الرغم
على أنه لا يعرفني ولن يفعل تقريبا، ولكنني كنت كما الكثيرين أحب أن أسمعه وأنصت
لنصائحه البراقة.
"كن دقيقا"، هذا ما يحث عليه جوردن
دائما إلا أنه في نفس الوقت قد قدم نفسه في مقابلات مختلفة على أنه طبيب نفسي مرة،
ومرة أخرى عالم أعصاب ومرة على أنه خبير في البيئة، والحقيقة أنني لست بصدد فضحه
أو ما شابه لأن ذلك موجود بالفعل في مصادر سأضعها في نهاية المقال، ولكنني أريد أن
أسلط الضوء على أمر هام، ألا وهو لماذا أعجبنا به؟ في الواقع إن بيترسون يمنحنا
شيئا لا يوجد إلا في الدين ألا وهو الحتمية في بعض الأمور، أي أنها حقائق قاطعة،
ثم إنه – كما أندرو تيت – يحاول أن يساعدنا حتى نصبح أقوياءا في ذلك العالم، إذن
فما العيب في ذلك؟
المشكلة الرئيسية في ذلك الخطاب هي المناخ الذي
نشأ فيه، فرجل مؤمن كجوردن بالهيراركية والقوة وما إلى آخره من تمجيد للقوة،
كدعوته لنكون وحوشا، هو مناخ ينمي بالضرورة الكراهية والقمع وينتهي الأمر إلى ما
يحدث الآن في إسرائيل، فإسرائيل تفعل ما تفعله لأنها تستطيع، وهذا مثلا يذكرني
بمشهد في مسلسل البيكي بلايندرز لتوماس شيلبي حينما سأله أخوه الأكبر آرثر لماذا
يعلنون حربا على عائلة تشانجريتا، فقال لأنه يمكننا "because we
fucking can"،
هناك تشابه أليس كذلك؟ والمثير في بيترسون أيضا هو أسلوبه الدرامي في الحديث،
وتعقيده لأبسط الأمور، فمثلا حينما سئل في إحدى المقابلات عن حاله، قال "
رائع ومروع"، إلا أن ذلك التعقيد لا يأتي إلا في التوافه، فمثلا في كتابه 12
قاعدة للحياة، يملي عليك نصائح رائعة حتى تحسن حياتك، منها أن تقف فاردا ظهرك
دائما، مستندا إلى أن من يقف منتفخا كذلك فهو لديه مستوى مرتفع من السيروتونين
بناءا على نظريته العجيبة عن سلطعون البحر، والتي هي في النهاية غير دقيقة نهائيا،
ولكن ذكروني من يقف منتفضا جامدا أيضا؟ نعم، توماس شيلبي، ومن أفسد في الأغلب حياة
المحيطين به؟ توماس شيلبي أيضا سبحان الله.
في عالم تكون فيه أنت بطل الفيلم، وتكون كل
فصول حياتك كما فصول من حياة بطل رياضي أو شخص مشهور، فإن في ذلك العالم من
الطبيعي أن يحاول الكل أن يكونوا آلهة كما توماس شيلبي، وبالتالي حكماء وأقوياء
كما بيترسون الذي يعظ النموذج ذاته الخاص بتوماس، والحقيقة أن وجود رجالا حكماء
ضروري بالتأكيد، ولكن هنا فرق بين أن تكون حكيما وأن تبدو كذلك، فمثلا البابا
فرانسيس أو شيخ الأزهر، فهم أهل حكمة أليس كذلك؟ ولكن أين هم من القوة والسلطان
العالميين؟
إعادة نظرنا في بيترسون الأبله ذاك يجب أن تكون
شاملة، لتضم أبطالنا، وأفكارنا والنماذج التي نحتذي بها، فالاكتئاب المسيطر علينا
الآن ليس مسؤوليتنا كما يذعم أشباهه وإنما نتيجة الظروف، فلا نستطيع للأسف أن ننصح
الفلسطينيين أن يرتبوا أسرتهم، لأنه لم يعد لهم بيوتا بداخلها أسرة.
ماذا عن الغد؟
أعتقد أشد الاعتقاد أن ما يجري الآن قد غير
شيئا في جيلي من الشباب، وأخشى ما أخشاه هو أن تكون ردة فعلنا نقيضا تاما للوضع
الذي نحن عليه، بمعنى أن نفعل كل شيء مثلا نقيضا للغرب، والحقيقة أن ذلك ليس أصوب
حل، أهمية ما نمر به الآن هو أنه معمودية بالدم لجيل جديد يمكنه أن يحدث فارقا في
العالم مستقبلا، المقاطعة أهميتها ليست فقط في كونها تضر بالداعمين للصهيونية ولكن
لأنه فتحت أعيننا على طرق جديدة، وهذا ما يجب أن نركز عليه، ففي ظل الظروف
الحالية، الاقتصادية والسياسية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تلافي اليأس
والاكتئاب، ولكن قدرتنا على إرادة دروبا أخرى لنسلكها ستعطينا دائما الأمل، وذلك
لو يذكرني بشيء فهو يذكرني بتيريون لانيستر من مسلسل لعبة العروش، فهو لم يرد
الانتقام، ولم يرد المال في النهاية، وإنما سعى سعيا حثيثا نحو كسر عجلة القيادة
المتحكمة في عالمه، وذلك ليس بالتدمير وإنما بمحاولة بناء عالم آخر، وأظن أن هذا
واجبنا الأخلاقي في نهاية الأمر، حتى لا تظل دماء الأطفال على أيدينا، أن نحاول أن
نشيد عالما آخر على عكس الشعارات القائلة بأنك لا تملك سوى تغيير نفسك لا العالم، إن
الظلم الواقع اليوم على الفلسطينيين والقهر الذي نتذوقه كل يوم يجب أن يكون دافعا
لنا لمنع سياسات القوة نفسها من الاستبداد، أن نحول دون أن يقع ظلما آخر لشعب آخر
طالما أن القضية ليست بقضيتنا كما يفعل الغرب.
علينا أن نمتلك الشجاعة الكافية لنهدم العالم
الذي نعيش فيه ونبني عالما آخر، دون أية مساومات لأنه لا توجد حلول وسط، علينا أن
نملك الخيال لا للتحايل على قواعد اللعبة السياسية، بل لخلق لعبة جديدة.


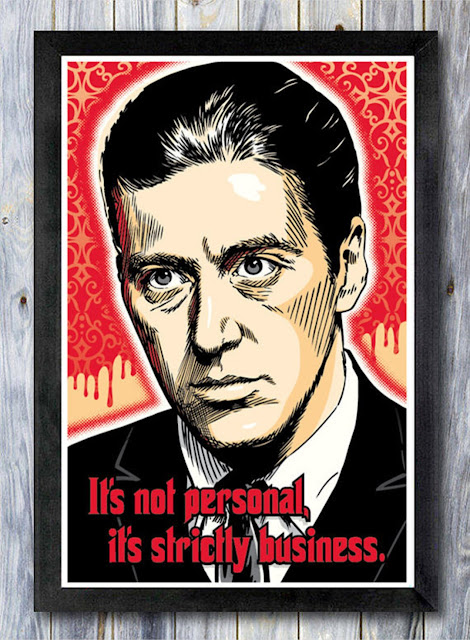

رائع تحليل و تفسير و تفنيد
ReplyDelete