أنا أعمل، ومديح في الإدمان
في نفس اليوم،
بعدما انتهت المسرحية، رحلت مع أصدقائي وتو ما ركبت سيارة صديقي حتى انفجرت باكيا
دون أن أنطق بكلمة واحدة حتى وقد استمر ذلك لأكثر من ساعة، لكنني استطعت البكاء
بشكل طبيعي، بجانبي أصدقاء لم يتفوه أحدهم بكلمة، حتى انتهيت تماما ومر اليوم
عاديا جدا.
انتشرت في الأشهر
الأخيرة بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، منشورات من نوعية
"أنا لنفسي، وأنا سأنقذني، وأنا بطلي" ومثلا "لن يأتي أحدٌ لإنقاذي
وإنما أنا منقذي" وما إلى آخره يكتبها في الأغلب من هم من نفس عمري أو فئة
الشباب بشكل عام، ومقاطع الفيديو القصيرة على إنستجرام أو فيسبوك، يظهر فيها جوردن
بيترسون أو أحد لاعبي السلة أو مغني راب، وتكون أغلبها على شاكلة واحدة من حيث
المضمون مهما اختلفت الأساليب في الحديث، ما هو مضمونها؟ هو أن تكون وحشا، وأن
تنظر في المرآة فإن الحرب كلها بينك وبين ابن العاهرة الذي تحدق فيه، وأن الطريق
وحيد، ولا أحد يهتم بما تشعر، ومشاعرك لن تؤتيك نفعا..إلخ.
والحق الحق أقول
لكم إني انغمست لسنوات في المقاطع التي من نفس النوع، وتلك الثقافة بمعنى أصح التي
تنعكس علينا حرفيا في كل شيء، من أول الأفلام، الكتب، أغاني الراب وصولا لمنشور
تكتبه منورة الأمورة على فيسبوك أو تويتر، وتلك الثقافة اكتشفتها تلك السنة بشكل
لم أكن أعهده من قبل، بل لم أتخيله من الأساس، ولكن بعد التعرض لعدة حوادث في
العام الجاري الحافل بالنسبة لي، وجدتها تغلفنا جميعا، فمثلا في أغاني إمينيم على
سبيل المثال لا الحصر من أغنية "Space bound" حين قال "لا أحد
يعرفني أنا بارد، أمشي ذلك الطريق وحيدا.."،
و"واحد واحد" لأبيوسف التي قال فيها " أغرق نفسي بس ميقولوش
نفسه كان قصير"، أو مشهد في فيلم "Good Will
Hunting"
الذي سأل في المعالج النفسي مات ديمون البطل إذا كان يشعر بالوحدة أم لا، فحاول
مماطلته بأن لديه عدد من الأصدقاء وهذا يكفيه، فسأله مرة أخرى من يستطيع أن يقوم
بالتواصل معه، حينها توتر الآخر وأخبره بأن لديه الكثير، منهم هم؟ شيكسبير، نيتشه،
فروست..إلخ، ليجيبه المعالج بأنهم موتى.
في كتابه
"إخفاق التواصل"، حكى يوهان هاري عن الاكتئاب الذي أصاب أهله حينما
انتقلوا إلى المدينة مع تغير طباع الجيران قبل وبعد الانتقال، حيث إن الجيران قبله
كانوا يعرفون بعضهم ويتحدثون ويشاركون بعضهم البعض بالأخبار، لكن في المدينة
الجديدة كان الكل بالكاد يميز جاره وهو ماشٍ في الشارع، وهذا كان أحد أنواع الفقد
التي عرضها يوهان هاري في ذلك الكتاب كأسباب طبيعية، لا يلتفت لها أحد، للاكتئاب
والقلق، فالمدينة كما يمكننا أن نرى في الأفلام الأمريكية، وسنضرب المثال بفيلمين
مختلفين أشد الاختلاف عن بعضهما، المشهد الذي ينزل فيه ويل سميث إلى الشارع بعدما
قُبِل في الوظيفة التي حلم بها من فيلم "ملاحقة السعادة"، ومشهد آخر
لكيانو ريفز من فيلم "ماتريكس" الذي وجد نفسه فيه في الشارع وسط الناس
يتخبط فيهم، بعيدا عن رؤية المخرجين والسياق الدرامي وما إلى آخره، فإننا إن وضعنا
البطلين جانبا وراقبنا حركة الناس في الشارع، فسنجد أن الغالبية الساحقة تمشي
مُسيرة نحو تمرين أو عمل، كلها بنفس الوجه الذي لا يُبدي مشاعرا، وهذه ليست محاولة
لتلفيق فكرة أحاول إيصالها بأمثلة مشوشة، جرب أن تكون من الإسكندرية واذهب للقاهرة
وامش في الشارع، وأختار القاهرة تحديدا بسبب أنماط العيش فيها، في كل مرة أذهب
فيها للقاهرة سنويا أتعرض لتلك الصدمة.
ماذا حدث للسيد
صفر في النهاية؟ قام بقتل السيد جونز رئيسه في العمل، ويمثل ذلك الحدث نقطة انهيار
للسيد صفر استطاع من بعدها أن يخبر ديزي أنه يحبها، ذلك الحدث كان مشابها للكثير
من النقاط التي رأيتها وخبرتها على مدار حياتي حتى وإن كنت شابا، فحينما تملأ
الكوب عن آخره حتما سيفيض خارجه، والضغط المستمر يولدُ إما أخطاءً، كما في كرة
القدم، أو انفجارا، وهذه حقيقة لا ريب فيها، فمثلا، بعدما كنت بمثابة الصديق
"اللوح" لأصدقائي لسنين، وصلت في مرحلة ما إلى نقطة لا يمكنني من بعدها
أن أظل كما كنت، وهكذا وصلت لنقطة انهياري الخاصة – دون أن أقتل أحدا لحسن الحظ –
ومن بعدها أحاول أن أعيد اكتشاف ذلك العالم الكائن حولي والآخر الكائن داخلي
والتوفيق بينهما قدر المستطاع، وكما حدث مع السيد صفر في النهاية، أنه أُعدم، حدثت
معي بعض المواقف التي جعلتني في بعض الأوقات أود لو أرجع للشخص الكتوم الذي كنته،
من نظرات تقول إنني كئيب، للوم كبير لقلة إنتاجيتي..إلخ.
إذن فإن صفر هو
المجرم في النهاية، أليس كذلك؟ وأنا الضعيف في النهاية؟ السؤال الأفضل طرحه هو
لماذا؟ لماذا وصل صفر لتلك المرحلة مثلا؟ هنا سينكشف الكثير أمامنا.
ذكرت في مقال سابق
على مدونتي، مقتبسا من كتاب إخفاق التواصل، أننا لا نستطيع أن ندرك في كثير من
الأحيان محدوديتنا فنقوم بإلقاء اللوم على أنفسنا وتحميلها المسئولية في محاولة
للشعور بأننا نسيطر بعض الشيء على الأمور، وبذلك فإننا نشعر كثيرا بالندم والحزن
والذنب على أشياء حدثت لنا وليس لنا دخل بها، لكن ماذا سنسمع حينها؟ ماذا يقول
المؤثرون لنا؟
حينما تكون عناوين
مقاطع فيديو جوردن بيترسون مثلا هي أنك لا يجب أن تكون لطيفا، وأن يخبرك إريك
توماس الشهير ب"إي-تي" أنك من نوعية الملوك وأنك مصدر حرج للمملكة في
وضعك هذا، أو يحكي لك توني روبينز عن قصة الشحاذ الذي طلب منه ربع دولار على ما
أتذكر وأنه قال له هل هذا كل ما تريده؟ فقال الآخر إنه كل ما يحتاجه منه، فقط ربع
دولار، ثم ينهي قصته بأن الحياة تعطينا كل ما نريد ونطلبه ضاربا بذلك الشحاذ مثلا
في ضيق الأفق لأنه كان يمكن أن يعطيه مئة أو مئتي دولار! حينما تكون محاطا بتلك
الثقافة الفردانية التي تركز عليك أنت ولا تركز بأي حال من الأحوال على ما يحيطك، حينما يركز توني روبينز في قصته المزعومة على كون الشحاذ قليل الطموح بدلا من التساؤل عن الأسباب التي جعلته شحاذا ولماذا سمح المجتمع ببقائه على تلك الوضعية، فتكون أنت البطل المغوار المُنتظر ليغير حياته وإذا لم يحدث ذلك فإنك ستوصف بالفشل
وستُلام، فيمكننا أن نتفق بكل أريحية مع مغني الراب مروان بابلو في أغنية
"سفاحين" التي أصدرها بإسم داما وقال فيها "عيطت قدام ناس في مرة،
كدا عندك إحساس ها؟ يا تقتل ***** عشان خطر علينا"، وسيكون كل سلوك ينم عن
الأنا منطقيا ومبررا، كل تباهٍ بالقوة لن يصبح مذموما، وسيصبح العالم الذي يعيش
فيه دان بلزيريان عاديا، وفلكس الفقدان ملكا، أليس كذلك؟
في مناظرة أقيمت
بين الطبيب جوردن بيترسون وبين الفيلسوف والمفكر سلافوي جيجك، سخر الأخير من
بيترسون أيما سخرية قائلا "إنك لن تغير العالم بترتيبك لسريرك كل يوم
صباحا"، بالطبع هنا لم يقصد جيجك بذلك فكرة العادات الذرية وبناءها، إنما قصد
فكرة المسئولية الفردية، بحسب فهمي، التي تجعلنا أسيادا لهذا العالم، وهذا ملموس
جدا حتى أنني ظللت أفكر لبعض من الوقت مراقبا تفاعلات الناس وبخاصة الشباب مع
بعضهم، وتساءلت أين الشيطان إذن؟ أعني إننا ننصب أنفسنا آلهة دون أن ندرك ذلك، هل
المراهق الذي يريد أن يصبح لاعب كرة في فلسطين أو أوكرانيا أو في النمسا مثلا أيام
هتلر مذنب في إخفاقه بتحقيق ذلك الحلم؟ يمكن القول إن المثال متطرف وبعيد بعض
الشيء لكننا يمكن أن نقيسه على أبسط الأحداث التي تمر علينا مثل تنسيق الجامعات،
الحوادث، الاكتئاب.
لا أتذكر أين بالضبط سمعت أو قرأت ما سأكتبه الآن، لكن حينما تكون في عالم مضطرب مختل فإنك وبلا شك ستقوم بفعل شيء من اثنين، إما أن تنتحر (ومعنى الانتحار هنا أوسع من قتل المرء لذاته بيولوجيا، وإنما اجتماعيا ونفسيا)، أو أنك بكل بساطة ستحاول أن تتوافق معه وستعطيه المنطق، تماما كتجربة أجريت حينما ذهب شخص لمقابلة عمل في شركة وجلس وسط مجموعة من الممثلين، فإذا بهم يقفون جميعا بدون إعطاء أي سبب، حينما يسمعون صوت صفير، ورويدا رويدا بدأ الشخص الأول بالاستغراب ثم، في نهاية الأمر، أصبح يقف معهم في كل مرة ينطلق الصفير، هل تلك حالة فردية؟ لا، لأن هناك العديد من الأشخاص أجريت عليهم نفس التجربة في ذات الوقت، كل يدخل بعد الآخر، أليس ذلك واقعيا؟
وبذلك فإننا نتحول
لمثال أبيوسف المذكور سلفا ونغرق أنفسنا بالفعل حتى لا يقال إن نفسنا قصير، ونعتذر
بشكل أو بآخر عن كوننا "نكديين"، كلنا في النهاية نتحول من
احتياجنا لقول "أنا أحبك" لقول "أنا أعمل".
وهنا سيظهر سؤال
"إن ما يقوله الذين ذكرتهم ينفع، فما تفسيرك؟"، الإجابة هي لو أنك
ذهبت لمدرسة يدرسون فيها الحساب، المعتمد كليا على المنطق، في منطقة نائية جدا
وعرفت أن ال1+1 لا تساوي 2 وإنما تساوي 3، وهذا الشكل المعتمد لديهم فإن إجابتك
البديهية والمنطقية ستصبح خاطئة وستكون غير متفوق في الحساب، أليس كذلك؟ وبالتالي
فإن العيش في العالم الذي لا يدفعنا إلى النضج، وإنما يدفعنا للكسب والإنتاج،
والذي يُعلي كفة الترفيه على كفة العلم والثقافة والدين، حينما نعيش في مجتمعات –
كما في كتاب قلق السعي إلى المكانة لألان دو بوتون – يكون المعيار الأكبر فيها
للإنجاز وتزعم أنها تمنح فرصا متساوية للناس فإذا أخفقت فإنك لا تستحق مكانا، لن
تكون حساباته صحيحة، ولكن قوانينه ستعطيها المصداقية.
في ذلك الطريق
الوحيد الذي سنمشيه أنا وأنت وإيمنيم وناهد وخالتك وعمتك، سنكون كما قيل في أغنية
"مكانٍ آخر- Autre part"
إننا لا نكبر وإنما نُبدل فقط جرس الفسحة بآخر، وهذه الجملة في حقيقة الأمر تستحق مننا تأملا حقيقيا، أن نعيد نظرنا في
النضج، وهذا ما أرى أن جيلي يخطئ كثيرا في تفسيره، لأنه ليس الكسب، وليس الاستقلال
المادي فقط، وليس القدرة على إخفاء المشاعر، إنما النضج يتحقق حينما ننحي بقدر ما
نستطيع المسكنات الحياتية ونأخذ الحياة كاملة، وأن نستطيع أن نحيا الأسئلة كما
الإجابات، النضج يبدأ حينما ندرك أين نحن وإلى أين نذهب.
نتيجةً لما سبق، فإننا يمكننا أن نستنج غياب مفهوم إنساني مهم ألا وهو (الإرشاد)، فتلك الأفكار حول النضج ومحاولة تحقيق الذات الدائمة تفقدنا في الطريق معنى الإرشاد، وبالتالي فبعدما كنت أبحث عن الأهل وتحديدا الأب في البيت، صرت أبحث عن نموذج الأب والأهل في الشراع واللقاءات الفضائية وفي مغنيين لديهم تقريبا نفس عمري أو أكبر قليلا.
وعليه فإن جيلي
يعاني لا من حاجته لأن يكون مرئيا ولكن من حاجة ليست أصيلة بشكل نقي وهي الحاجة
للإظهار، سأقول إنني أتغير، وإنني أنمو، سنكتب جميعا على حساباتنا في مواقع
التواصل الاجتماعي إننا نثق بالطريق مرفقين فوقها صورتنا في الجيم، ما طريقك يا
صديقي؟ لا أعلم، لكنني سأثق به، سنستعير سلوك كوبي براينت لاعب كرة السلة المتوفي
حينما كان في الملاعب، ونبين أننا نعمل بجد وأننا سنتفوق على الكل، في ماذا؟ لا
أعلم، لكننا سنتفوق على الكل، ومن الملاحظ بشكل مفجع أن أثر الراب في الفترة
الأخيرة، والتي أحب أن أسميها فترة قطف الثمار، إذ إنها الفترة التي تتسابق فيها
الشكرات على التعاقد مع مغني الراب وسُلط النور بقوة على الراب، إن الشباب
والمراهقين يعانون من جنون عظمة غريب، فتكون كل الأغاني، عكس فترة التكوين في مشهد
الراب التي سبقت كون الراب ترندا، على شاكلة واحدة فأنا سأخطف حبيبتك، وسأعمل
دائما، سأحقق الملايين، وكلنا سنواعد المضيفات، وهذا يذكرني بمشهد لتوفيق الدقن
حين قال "الناس كلها بقت فتوات أمال مين هيضرب؟"، فنتحول من
ال"نحن" ل"أنا" ونعيش سويا في مجتمع يقوم على رؤية فردية
للذات لا تستطيع، مهما بلغت من كمال جسدي ولياقة وتفوق مادي، أن ترى خارج حدود
نفسها مهما أبدت عكس ذلك، وهذا قد أشار له يوهان هاري في كتابه.
وهنا يجب أن أُقحم تعليقا مهما وسط الحديث، وهو تعليقي على ما أشهده من تشويه للصداقات، فالصداقة كمفهوم أصبح في مهب الريح، إذ بدلا من أن تقوم مثلا على التوافق والمحبة والصدق، أصبحت تقوم بناءً على مستوى خفة الدم لدى المرء، وملبسه وذوقه الموسيقي، تلك الأشياء التي تُعد كماليات الصداقة أصبحت هي الأساس، وبالتالي فإن الروابط بعدما كانت مثلا من معدن، أصبحت الآن من قش مرشوش عليه بريق لامع، وبالتالي فإن المرء يكون في كثير من الأحيان "عامل حر-Freelancer" في علاقاته، فكل تجمع بشخصية، وبالتالي تغيب فكرة "العبوة الكاملة" أي أن سندويتش البرجر الذي تأكله كما هو لن يكون السندويتش، بل تقطم مرة اللحم، ومرة الخس، ومرة الطماطم، وهذا المثال ليس ساذجا نهائيا، فتجد الشخص يجزء ذاته و"يفرشها" كما لو كانت سجادة حتى تغطي أكبر قدر من التجمعات ليسد عبثا الفراغ الذي بداخله، نحن، أنا وأبناء جيلي، نعاني من كوننا لا نستطيع أن نكون بكاملنا في صداقاتنا، والصداقات نفسها تصير كنفس الدخان الذي يكيّف الدماغ ثم يتبخر في الهواء، ولذلك من الأهمية مقاما كبير لأن الإنسان، مهما حاول المجتمع الحديث أن يقنعنا بعكس ذلك، يحتاج للآخر، فبذلك النمط من العلاقات وأشباه الصداقات فإننا نظل رغما عن كل ما نفعله نشعر بالوحدة القاتلة، ووينقصنا دائما نوعا من الاتصال لا نعرف طعمه إلا نادرا.
جلست في إحدى
المرات في كليتي وحيدا واضعا سماعاتي في أذني وراقبت الشباب في حركتهم وتفاعلاتهم،
وما استطعت أن ألاحظه بشدة، هو أنهم يسيرون بشكل آلي في علاقاتهم لدرجة مرعبة،
فتجد النحلة تنتهي من زهرة فتطير لأخرى، وهذا أقرب مثال للنمط الذي وجدته ويمكنني
بكل أريحية أن أعممه على نطاق واسع جدا، ليس لأنني جهبز وسابق سني، بل لأنني فقط
سكت قليلا وراقبت، ويمكنك أن تراقب وترى أنت أيضا، إننا نستهلك العلاقات ولا
ننشئها، علاقات مفرغة من المعاني، تماما كما الأكل سريع التحضير، لذة لحظية فقط،
وبذلك فإننا نعيش في وحدة تجعلني أتحدث عنها الآن وعن نتائجها.
مديح في الإدمان:
"ماتصحينيش يامّا
دانا حلمي سعيد
مش عايزة أفوق يامّا وهمي يزيد
باينها دي ليلة طويلة وبهرب من الواقع
وبهرب من نفسي، الدنيا دي فيها حاجتين
هما الفلوس ومعاها الكيف"
-الماسX
الوايلي، الكيف.
أؤمن إيمانا شديدا
أن الميمز أو الكوميكس تشكل مادة خام للتأمل وقد تعبر عن أشد التعقيدات بسلاسة
شديدة جدا لما تفعله من انعكاس لصانعها ومجتمعه، وواحدة من أفضل الميمز هي تلك
التي يضعها الرياضيون أو الذين يبدأون الرياضة، في ظل ارتفاع الأسعار، عن الأب
الذي يعطي ابنه ربعا من الحشيش أو سجائر بعد سماع احتياجات ابنه من (الطعام الصحي)،
والحقيقة أن المقطع الموضوع أعلاه من أغنية الكيف وذلك الميم، يمكنهما بكل بساطة
اختصار مسافة طويلة جدا علينا إذا أردنا الحديث عن الإدمان ومشروعيته في الزمن
الحاضر، فقط إذا أضفنا اقتباس من كتاب "Fortify:
fight the new drug-
الحصن:حارب المخدر الجديد" قد ذكرته مسبقا في مقال، وهو أننا حينما نفعل شيئا
مضرا لنا، مثل المخدرات، اضطراب الأكل، الإباحية، تشويه الجسد، فإننا لا نفعل ذلك
إلا لأننا لا نعرف شيئا أفضل من ذلك، هنا يمكنني أن أقدم لكم الإدمان بكامله من
وجهة نظري.
فبعد حديثنا عن
العالم ذي الثقافة الفردانية الذي نعيش فيه الآن، والصعاب الضخمة التي تواجهنا فقط
لنكون كاملي الإنسانية أو أسوياء، يحضرني سؤال ألا وهو لماذا إذن لا أدمن المخدرات
وأدخن السجائر وأشاهد الإباحية؟
وفي هذا الجزء من
الحديث سأتحدث باختصار عن الإدمان متخذا الإباحية مثالا لأهمية ذلك وسأوفيها حقها
قدر المستطاع في حديث لاحق.
يُعد إدمان
الإباحية من التابوهات، وحينما يتم تناوله يحدث ذلك بسذاجة مفرطة التدين أو
النصائح والاندفاع، ذلك لما يصحبه من عار يلاحق المدمن أو المدمنة، هذا إذا ما استوعبنا
أساسا أنه إدمان، فنحن نعتبره أمرا طبيعيا ملتصقا – فقط – بالشهوة، وهذا به جزء من
الحقيقة لكنه ضئيل، ومجلبة للعار والخزي، فإنك طائش بالتأكيد أو عاهرة إذا أقدمت
على ذلك، وبالتالي فإن التفسيرات المطروحة للإدمان الذي يكاد يؤثر على المخ نفس
تأثير الكوكايين، والذي يغير في نفس المرء تغييرا عظيما، تكون مرتبطة أكثرها
بالفساد الأخلاقي وقلة التدين، ولكن..
مثلي مثل أبناء
جيلي فإن المواد الإباحية تُعرض أمامنا في كل مكان، وذلك ليس منطبقا فقط على
الأفلام الإباحية البحتة وإنما في الحديث والصور والإيحاءات، وبالطبع هناك مساحة
للخطأ لست حنبليا اتجاهها، ولكنها لا تحاصرنا فقط بذلك الشكل..
أحد أكبر أسباب
الإدمان هو الوحدة التي نعيشها، لأننا في الإدمان هنا لا نبحث فقط عن لذة وإنما
نبحث عن اتصال عميق يربطنا بعدما فشلنا في الحصول عليه في العالم الحقيقي، ففي
العالم الذي نعيش فيه، الذي يحاصرنا بالوحدة وبالزيف، فرصة أن تحصل على شيء من
خلال طريق صحي يكون أمرا بالغ الصعوبة، وبالتالي فإننا لا نجد أمامنا سوى النساء
والرجال الذين يبيعون أنفسهم تحقيقا للعرض والطلب منفذين بذلك أكبر خيالاتنا
الفانتازية، ولست أنوي وعظا عن الخطيئة وكوننا جميعا ضحايا وما إلى آخره.
لكن ألم يسبق لك
التفكير ولو لدقيقة والتساؤل لماذا؟ هل هناك سبب آخر سوى أننا
"تعبانين"؟ عرض فيلم "فيلم ثقافي" ذلك بدقة شديدة جدا، حينما
قيل في مشهد إن الخطأ في النظام.
التوقف لدقائق،
كما توقف صفر وتساءل، لماذا نحن هكذا؟ لماذا أنا لست واعيا للحظة؟ لماذا أدمنت؟ كل
هذا يتطلب جهدا جبارا منا، وقد تحدث جايسون مار على منصة تِد عن ذلك ذاكرا قصته
مع ذلك الإدمان فقيل له من أب اعترافه إن الإباحية ذاتها ليست مشكلتك، وإنما هي
عرض لشيء أكثر عمقا، (وهذا ما أشير إليه فيما يتعلق بالاكتئاب والقلق في كتاب
إخفاق التواصل) هذا الشيء يختلف من واحد لآخر، لكن هل يمكن أن تكون هناك أسباب
مشتركة له؟
أن تكون وحيدا،
وأنا أصر على مسألة الوحدة تلك، تتغذى على العلاقات التي حولك دون أن تقيم علاقات
حقيقية تشبع احتياج بداخلك، لا تستطيع أن تحب أو تتزوج لظروف مادية، أو أن تكون في
مجتمع لا يريد أن يرى منك غير جانب واحد، وحينما تكون مضغوطا وقلقا، تعاني بداخلك،
ولا تستطيع أن تتكلم لأنك قد اقتنعت بشكل كامل أن الطريق وحيد، فلا بأس نهائيا من
أن تشاهد فيلما إباحيا يرفع لديك مستوى الدوبامين ويجعلك تدخل في حالة من الخدر
ولذة شديدة مكثفة، في الوقت الذي يظل أساسا مستوى الدوبامين مرفوع لديك وتصير شرها
اتجاهه بسبب تغذيك على ما تعطيه لك مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام التيك أواي
المعروضة على المنصات، أليس كذلك؟ لن تبذل لا مال، ولا جهد، فقط اكتب ما تريد
وستناله.
وبالتالي فإننا في
الحقيقة لا نمدح الإدمان، ولكن أليست تلك الطريقة التي يمكننا أن نفكر بها في
مختلف الأمور الإدمانية أو تلك التي توفر لنا لذة لحظية؟ من أول الميث والإباحية
حتى رغيف كبدة الفلاح، العالم الذي نسكن فيه، وهذا جزء من سنة الحياة بالطبع،
الصحيح فيه صعب، وهذا بديهي، لكن الفكرة الأسوأ هو أن العالم يغذي خدرنا ذلك، ولا
يلتفت لمطالبنا الإنسانية، فننسى كلمة أحبك، ونقول دائما أنا أعمل، وهذا ما يحدث
حقا في رحلة الإدمان حيث يستحوذ علينا الإدمان ويفقدنا لذة شغفنا الحقيقي، فمثلا
لو كنت تهوى عزف الموسيقى، ستلاحظ بكل سهولة كيف تنطفئ اتجاهها حين تقع في إدمانك
أيا كان سواء كان إباحية، طعاما، وسائل تواصل، سجائر، وعليه فإننا نظن أننا لا
نستطيع أن نعيش بدونها، نحن نريد كما الماس في الأغنية ألا توقظنا أمهاتنا لأننا
نريد الهرب "ما تصحينيش يامّا دانا حلمي سعيد"، نحن نرمي كل اللوم على المسكن (الإدمان) ولكن إذا اختفى مصدر الألم الحقيقي فما الحاجة للمسكن، أليس ذلك منطقيا؟ تلك المعالجة هي التي تحتاج منا قدرا ليس بالقليل نهائيا من الشجاعة، مواجهة أننا إذا أردنا النضج فعلا فذلك لن يكون عبر التكبر أو القوة أو النقود، إنما من خلال أن نحيا جميعا بقوتنا وضعفنا، أن نكون نحن كما خُلقنا دون اقتطاع، أن تكون كتوما ليس بالأمر الصعب تلك الأيام، وإنما أن تكون إنسانا يُعبر عن ذاته بكاملها.
الغرض من الحديث
بكل بساطة هو أنني أرى أصدقائي وأقاربي معذبين وأعي ذلك، لكنهم لا يتحدثون، الكل
يظن السوء بنفسه، كذلك الذي يرى أن خطبا ما أصاب عقله لأنه مكتئب دون أن يتأمل
حياته، وبكل صدق أريد أن أقول إنني سئمت من رؤيتهم في تلك الدوامة التي نصير فيها
جميعا صفر، والشباب الذين يبحثون عن فيلما ثقافيا، كلنا نغرق أنفسنا، وعليه فإنني
آمل أن أضيء لأحدهم شرارة تمكنه من أن يكون إنسانا بحق، أن يكون مستقيظا، أن نكون
كلنا كذلك.


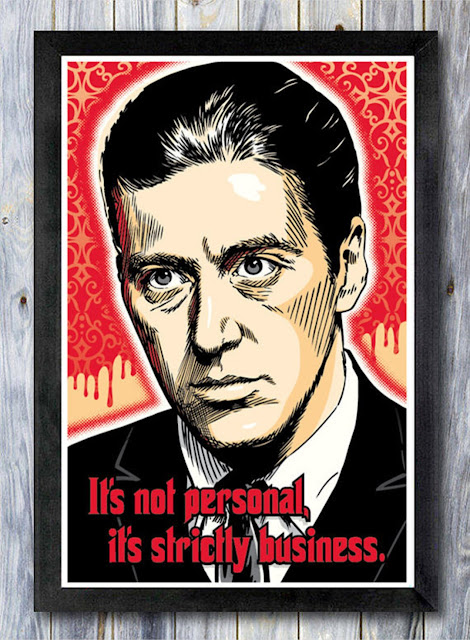

Comments
Post a Comment